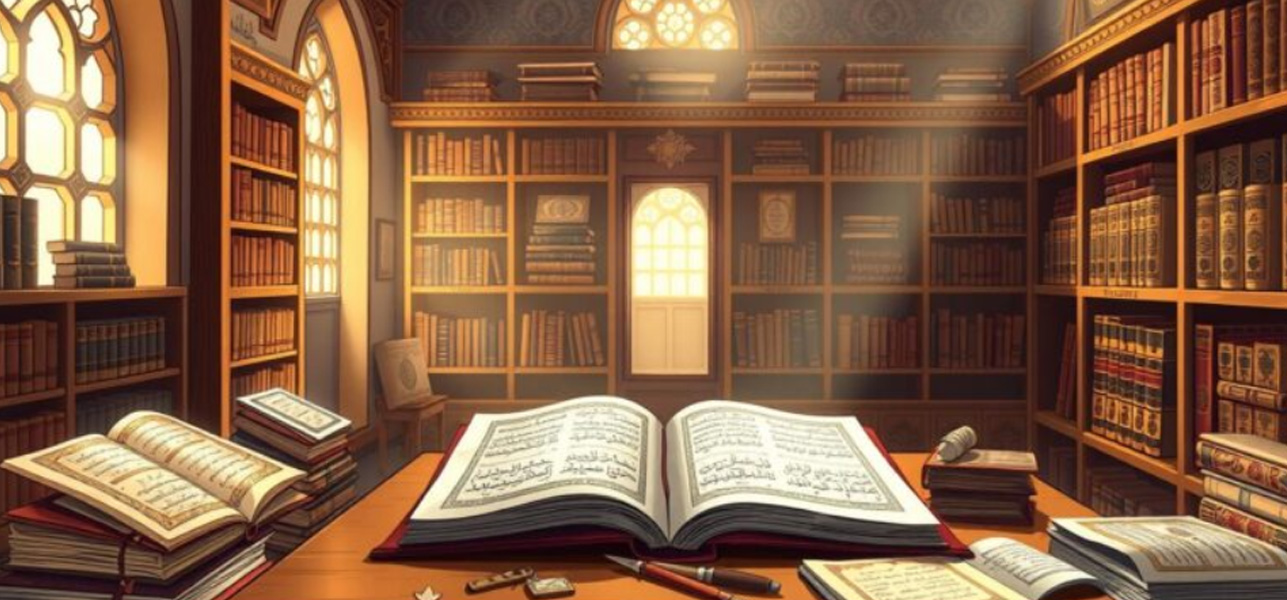بقلم د. صافي قصقص
مقدمة تحريرية للنشر الصحفي
في زمنٍ تتسارع فيه التخصصات وتتجزأ فيه المعارف وتبهت فيه البوصلة الأخلاقية، يواجه العالم أزمةً تتجاوز التعليم والمناهج لتصل إلى جوهر الإنسان ورؤيته للوجود.
فهل يمكن للمعرفة أن تُستعاد كقيمة مو ِّ ‘حدة، تربط بين العقل والروح، بين العلم والحكمة، بين الغاية والوسيلة؟
في هذا المقال، يق ‘دم المفكر والباحث الدكتور صافي قصقص مقاربةً إسلامية أصيلة تُعيد التوحيد إلى قلب العملية التعليمية والمعرفية، مستعرضًا الجذور الفلسفية للتفكك المعرفي في الغرب، ومقترحًا نموذجًا بديلًا يستلهم من التراث الإسلامي دون أن يغلق الباب أمام الاستفادة من تجارب الأمم.
الملخّص
يتناول هذا المقال الأطر المعرفية المتباينة بين التقليدين الفكريي’ن الإسلامي والغربي، مر ‘كزًا على مفهوم التوحيد بوصفه أساسًا للمعرفة في الرؤية الإسلامية. فالتوحيد، المتج ‘ذر في كون موحَّد وهادف، يدمج بين الروحي، والأخلاقي، والميتافيزيقي، والتجريبي في نموذج معرفي وتعليمي متكامل تعلمناه كمسلمين من
مصدر إلهي واحد، هو الله سبحانه تعالى، الذي أنزل علينا القرآن كتابًا للهداية والمعرفة. وعلى النقيض، تميل الحداثة الغربية، لا سيما منذ عصر التنوير، إلى فصل المعارف عن الدين والقيم، مما أدى إلى تجزئة التخصصات وعلمنة المناهج التعليمية، ونتج عن ذلك في كثير من الأحيان انفصالٌ بين المعرفة والمعنى.
ومن خلال استعراض الخلفيات التاريخية والفلسفية لهذا التباين، يدعو المقال إلى تجديد الانخراط الفكري الإسلامي عبر التكامل النقدي، واستلهام الحكمة من مصادر متن ‘وعة دون التفريط بالمرجعية المعرفية الإسلامية. ويختتم المقال بالدعوة إلى نموذج تعليمي يعيد وحدة المعرفة، ويعالج الأزمات الأخلاقية المعاصرة، ويُعيد للبحث الأكاديمي بُعده الروحي.
مقدمة
لطالما تمي’زت الحضارات الإنسانية بسعيها الدؤوب نحو المعرفة، غير أن الرؤية الكونية التي تحدد كيفية فهم المعرفة واكتسابها وتطبيقها تختلف من تقليد إلى آخر. ففي الفكر الإسلامي، تتجاوز عقيدة التوحيد، أي وحدانية الله، نطاق العقيدة إلى مجال المعرفة والميتافيزيقا والأخلاق، لتؤكد أن المعرفة كل’ها مترابطة،
وتنطلق من مصدر إلهي واحد، هو الله تعالى، الذي أنزل علينا القرآن كتابًا للهداية والمعرفة. في المقابل،
الميتافيزيقية والأخلاقية، مما أدى إلى تجزئة التخصصات وعلمنة التعليم.
يستعرض هذا المقال الأسس المتباينة للمعرفة في كلا التقليدين، مبرزًا الوحدة الشاملة المستمدة من التوحيد في الإسلام، مقابل التوجه التجزيئي والعلماني في الأكاديميا الغربية. وفي الوقت نفسه، يؤكد المقال على أهمية التعددية الفكرية من خلال استحضار الحديث النبوي:
“الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها.”
التوحيد كأساس معرفي
في الرؤية الإسلامية، يُع ‘د التوحيد مبدأً من ِّ ‘ظمًا للكون ولجهود الإنسان المعرفية، وهو يؤسس لعدة مفاهيم:
أن كل المعرفة مصدرها الله، خالق الكون ومُن ِّ’زل الوحي.
أن الواقع موحَّد وهادف وذو معنى، والمعرفة التجريبية )علم الخلق( والوحي الإلهي )علم الوحي( ليستا متعارضتين بل متكاملتين.
أن التخصصات مترابطة، فالأخلاق، والميتافيزيقا، والروحانية، والعلوم، والشريعة، كلها أجزاء متكاملة لفهم الخلق وتحقيق مسؤولية الإنسان كخليفة في الأرض.
أن المعرفة لا تُطلب لمجرد الاطلاع، بل من أجل التح ‘ول الأخلاقي وتحقيق العدالة والتق ‘رب من الله.
ويشير المفكر المسلم سيد محمد نقيب العطاس إلى أن مفهوم الأدب، أي ترتيب المعرفة ترتيبًا صحيحًا وفقًا للحق، هو جوهر التربية الإسلامية، وأن هذا الترتيب لا يتحقق إلا ضمن إطار التوحيد الذي يو ‘حد بين أهداف المعرفة ومصادرها وطرق توظيفها.
التحوّل المعرفي في الغرب: من الوحدة إلى التفكك
علمنة المعرفة: إذ أصبحت تُطلب بمعزل عن اللاهوت أو الميتافيزيقا، وحل العقل والتجربة محل الوحي كمصدرين للحقيقة.
تجزئة التخصصات: فُصلت العلوم إلى مجالات مستقلة، كالعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية، والإنسانيات، كلٌ منها له منهجيته وافتراضاته، دون إطار أخلاقي أو ميتافيزيقي موحد.
الحياد القيمي والموضوعية: في سبيل تحقيق الدقة العلمية، تبن’ت الأكاديميا الغربية مبدأ الحياد تجاه المسائل الأخلاقية والروحية، ما أدى إلى ما س ‘ماه كثير من النقاد بـ “أزمة المعنى.”
وقد جادل الفيلسوف ألاسدير مكنتاير بأن الخطاب الأخلاقي الحديث في الغرب يتسم بعدم الاتساق، لأنه انفصل عن الأطر الغائية التي كانت تمنح اللغة الأخلاقية معناها.
ورغم أن هذا التفكك سمح بتحقيق تقدم تكنولوجي وعلمي كبير، إلا أنه أسفر أيضًا عن اغتراب روحي، وارتباك أخلاقي، ونظرة تعليمية نفعية تُعلي من الكفاءة على حساب الحكمة.
مقاربات مختلفة للتعليم والمعرفة
في المنهج الإسلامي، المستند إلى التوحيد، تُعتبر جميع أشكال المعرفة مترابطة وتنطلق من مصدر إلهي واحد. يُنظر إلى الوحي والعقل بوصفهما متكاملين، ويُقصد بالمعرفة تهذيب النفس وتحقيق العدالة والقرب من الله.
أما هيكل التعليم الإسلامي، فيعكس هذه الرؤية المتكاملة، حيث تُعامل مجالات مثل اللاهوت والفلسفة والعلوم والأخلاق على أنها مترابطة ومتداخلة في نموذج تعليمي شامل وهادف.
بالمقابل، يفصل النموذج الغربي الحديث، خصوصًا المتأثر بعصر التنوير، بين المسائل الدينية والميتافيزيقية وبين البحث التجريبي والعقلي. فالمعرفة تُطلب بمعزل عن الوحي، ويُعتمد على العقل والملاحظة وحدهما. كما يتسم النظام التعليمي الغربي بتفكك التخصصات، وغالبًا ما يُبعد القيم الأخلاقية أو
متكاملة للإنسان.
الحاجة إلى تكامل لا إلى رفض
رغم هذا التباين، لا يدعو التقليد الإسلامي إلى رفض الفكر الغربي جملةً وتفصيلًا. فقد قال النبي محمد ﷺ: “الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها.” )سنن الترمذي، (2687
وهذا الحديث يحث المسلمين على التماس المعرفة النافعة أينما وُجدت، بشرط أن تكون متوافقة مع الحق والأخلاق.
وقد جسدت الحضارة الإسلامية هذا المبدأ خلال العصر العباسي، حين انكب العلماء المسلمون على ترجمة ودراسة ونقد الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية، من خلال عدسة التوحيد والأخلاق الإسلامية.
وعليه، فإن الحل لا يكمن في الانغلاق الفكري، بل في إحياء المنهج التكاملي للمعرفة، المنطلق من غاية، والعقلاني في تحليله، والجذري في التزامه بالمرجعية الإسلامية.
نحو تجديد معرفي شامل
إن استعادة الرؤية التوحيدية للمعرفة يمكن أن تساهم في تجديد فلسفة التعليم والحياة الفكرية، ليس في العالم الإسلامي فقط، بل على المستوى العالمي أيضًا. ويتطلب ذلك:
تعزيز مناهج دراسية تُدمج بين العلوم والإنسانيات والأخلاق ضمن إطار روحي.
إعادة توجيه التعليم نحو الحِّكمة، وليس مجرد نقل المعلومات أو اكتساب المهارات.
إعداد علماء يتقنون التحدث بلغة الفكرين الإسلامي والغربي.
الإلهية.
وفي صميم هذا التجديد، تبرز ضرورة إحياء فهم معاصر للقرآن الكريم، يجعل منه كتابًا حيًّا، قادرًا على ملامسة واقع الإنسان الحديث وتقديم حلول عملية لأزماته المعاصرة. فالقرآن ليس كتابًا مغلقًا في الماضي، بل خطابٌ إلهي مستمر، يُعيد توجيه الإنسان إلى الحكمة، والمعنى، والمسؤولية.
وقد بي’ن المفكر سيد حسين نصر أن أزمة الحضارة الحديثة في جوهرها هي أزمة روحية، ناجمة عن نسيان البعد المقدس للمعرفة. والتوحيد، إذ يُعاد إلى مركز الخطاب، يمكن أن يكون سبيلًا إلى شفاء هذه الأزمة.
الخاتمة
إن التباين بين التوحيد وتفكك المعرفة في الأكاديميا الغربية الحديثة ليس مسألة نظرية فحسب، بل له انعكاسات عميقة على كيفية عيشنا وتعل’منا وتفاعلنا مع العالم. وبينما تختلف المقاربات الإسلامية والغربية في أسسها، فإن الحوار الصادق بينهما، المبني على الاحترام والنقد البن’اء، ممكن وضروري.
وعبر استعادة التوحيد كمبدأ معرفي حي، يمكن للمفكرين المسلمين أن يرسموا مسارًا نحو نموذج تعليمي يُعيد الوصل بين المعرفة والمعنى، والعلم والأخلاق، والعقل والروح.
وهذا ليس دعوة إلى الانغلاق، بل إلى التكامل، وإلى إحياء تراث فكري لطالما أضاء العالم بالتزامه بالحقيقة والعدالة ووحدة المعرفة.
المراجع
العطاس، سيد محمد نقيب. مفهوم التعليم في الإسلام: إطار لفلسفة إسلامية في التربية. المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، .1991
مكنتاير، ألاسدير. ما بعد الفضيلة: دراسة في النظرية الأخلاقية. مطبعة جامعة نوتردام، .1981 نصر، سيد حسين. المعرفة والمقدس. منشورات جامعة ولاية نيويورك، .1989
حلاق، وائل. إعادة تقديم الاستشراق: نقد المعرفة الحديثة. مطبعة جامعة كولومبيا، .2018